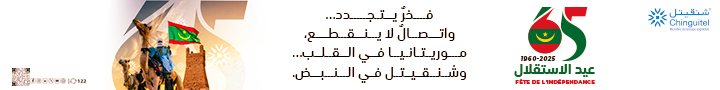ذكريات مع الفقيد جمال ولد الحسن/ الإداري محمدن ولد سيدي (بدَّنَّ)

لسبب ما، لا أكاد أنفك لحظة عن استعادة شريط الذكريات المثيرة في بعض الأحيان، لأستحضر من مكامنها بعض ما جمعني عبر الزمن، مع صديقي الأعز الفقيد أحمدو جمال ولد الحسن.
أذكر ذلك اليوم من شهر يونيو 1970 عندما التقينا لأول مرة في مدينة المذرذرة، وفي رحاب مدرسة أفولانفاه العريقة بالذات.
يومها، كنا نستعد لخوض مسابقة دخول السنة الأولى من الإعدادية، وكلانا وافد من مدرسة ابتدائية خارج المدينة.
ونظرا لصغر سنه آنذاك، المفصح عن مستواه الدراسي الطبيعي كما أتصوره، فأخاله كان المترشح الحر الفريد المسموح له بالاستفادة من ذلك الامتياز الخارق.
توطدت صلاتنا فيما بعد في العاصمة نواكشوط، حيث اعتاد أن يجذبني معه للمطالعة في المراكز الثقافية. كان المركز الثقافي المصري هو وجهتنا المفضلة. وللأمانة، فإن هذا المركز، كان أبرز المعالم الثقافية، التي حازت قصب السبق في احتضان الخطوات الحائرة الأولى للرعيل الموريتاني الأول، المتشبع من ينابيع الثقافة المحظرية، المنجذب بقوة إلى رحاب الثقافة العربية الإسلامية المعاصرة.
وتمر الأيام، وتفرق بيننا الدراسة ردحا من الزمن.
وتعود الكرَّةُ فيجمعنا الوطن وتفرق بيننا الوظيفة والتخصص، ولكن الصلة تبقى دائما وثيقة بيننا بقدر ما هي وثيقة بين الصحافة والأدب.
ولا زلت أتذكر بمرارة، زوال ذلك اليوم الساخن من أيام تامشكط، في المدخل الجنوبي لمنطقة آوكار، عندما اتصل بي من كيفه، الإداري الصديق محمدن ولد ابامين، ليخبرني على خط محفوظ من خطوط الشبكة الإدارية، بأن تلك الشعلة العلمية المتوقدة، قد انطفأت فجأة في ذلك الركن القصي من منطقة الخليج العربي! وعلى ذات الخط، أميز بصعوبة كبيرة من بين أصوات باهتة مختلطة، صوت الأستاذ يحي ولد سيد المصطف والي الحوض الغربي، وهو يتلمس الطريق إلى مكان ما من المنطقة المحاذية للحدود المالية من جهة منطقة الحوض الغربي.
كان السيد الوالي يسير ضمن موكب رسمي برئاسة المفوض مالكيف ولد الحسن، فبادرت أشاطرهما النبأ وأحزانه، وقد وقع علينا جميعا كما تقع الصاعقة.
تتزاحم الذكريات في مخيلتي عن الأستاذ جمال ولد الحسن، حلوها ومرها، ولكن أبرزها يبقى دائما ذلك الذي يتعلق بما يعتبره هو آنذاك مغامرة الخوض في تدريس الأدب الموريتاني.
نعم.. إنها مغامرة حقا بجميع المقاييس، الثقافية، والاجتماعية، السائدة آنذاك.
لم أعد أتذكر السنة، ولكن لا يزال محفورا في ذاكرتي ذلك اليوم الذي جاءني فيه زوالا وقال: "جئت لحاجتين، أولاهما أن تناولني نسخة من ديوان العلامة امحمد بن أحمد يوره، والثانية أن ترافقني إلى الجامعة لتحضر معي درس هذا المساء.. فقد استقر رأيي بعد تردد طويل على أن أبدأ تدريس الأدب الموريتاني في كلية الآداب، وارتأيت أن أبدأ بشعر امحمد بن أحمد يوره، وأن أتخذ منك شاهدا على ذلك. يبدأ هذا الدرس الأول في الساعة الثالثة ولم يعد يفصلنا عنه سوى نصف ساعة فقط".
ناولته الديوان، واتجهنا صوب، المعهد العالي للبحوث والدراسات الإسلامية، حيث مأوى الكلية الناشئة.
وفي الطريق طفق الأستاذ يتصفح الديوان. دخلنا القسم في الوقت المناسب، إذ أن حركة المرور آنذاك لم تكن بالدرجة التي تتعثر معها وتيرة سير الراجلين.
كانت الحجرة مكتظة بالطلاب، وقد علمت فيما بعد أن بعضهم متطفل مثلي وافد من فصول دراسية أخرى.
استطعت بمساعدة الأستاذ، أن أتبوأ مكانا معينا، وقفت فيه بين المصطفين في آخر الصف، وأذكر منهم المرحوم عبد الله ولد يحظيه، رئيس مصلحة الشؤون الأكاديمية آنذاك.
ما إن دخل الأستاذ حتى استتب الصمت داخل القسم، بالسرعة التي بادر بها إلى السبورة، وكتب بخطه الجميل، المزاوج بين التقليد والمعاصرة، قطعة ابن أحمد يورة المشهورة:
عَلَى الرَّبْعِ بالْمَدْرُومِ أيِّهْ وحيِّهِ
وإنْ كَانَ لا يَدْرِي جَوَابَ الْمُؤَيِّهِ
وَقَفْتُ بِهِ جَذْلاَنَ نَفْسٍ كَأنَّمَا
وَقَفْتُ عَلَى لَيْلاَهُ فِيهِ ومَيِّهِ
فقُلْت لِخِلٍّ طَالَمَا قَدْ صَحِبْتُهُ
وأدْنَيْتُهُ مِنْ دُونِ خِلاَّنِ حَيِّهِ
أعِنِّي بِصَوْبِ الدَّمْعِ مِن بَعْدِ صَوْنِهِ
وَنَشْرِ سَرِيرِ الشَّوْقِ مِنْ بَعْدِ طَيِّهِ
فَمَا أنْتَ خِلُّ الْمَرْءِ فِي حَالِ رُشْدِهِ
إذَا كُنْتَ لَسْتَ الْخِلَّ فِي حَالِ غَيِّهِ
فتعجبت من حسن اختياره وأشفقت عليه من الموضوع، إذ أن الحيز الزماني المتاح منذ تناول الكتاب، لم يكن يكفي لانتقاء موضوع الدرس، بله التحضير في ظروف أقل ما توصف به أنها لم تكن مصدر إلهام للأدباء ولا النقاد.
قلت في نفسي: وفقه الله في هذه، فأين المدخل؟
بدأ الأستاذ جمال درسه عن السؤال: ما معنى "أيِّهْ" في قول الشاعر:
[عَلَى الرَّبْعِ بالْمَدْرُومِ أيِّهْ وحيِّهِ]؟
عجز الطلاب جميعهم عن الجواب أو أحجموا عنه، ولعمري لو أن طلاب اليوم، سئلوا ذات السؤال لكانوا أعجز وأحجم.
فقال الأستاذ جمال: أيه معناها قل له: أيها! ثم استمر في إلقاء درسه، قال: بدأ الشاعر يخاطب نفسه المنطوية في ظل ضمير مستتر تقديره أنت.. أيه وحيه "أنت"..
ثم ما لبث المخاطب أن تحول من حال الضمير المستتر إلى حال الضمير الظاهر المتصل ضمير الفاعل وهو التاء في قول الشاعر "وقفتُ"..
وخلال البيت الثالث تطور المخاطب لدى الشاعر من ضمير متصل إلى خل منفصل ولكنه متصل وملازم بالدنو والمصاحبة الدائمة:
[فقُلْت لِخِلٍّ طَالَمَا قَدْ صَحِبْتُهُ
وأدْنَيْتُهُ مِنْ دُونِ خِلاَّنِ حَيِّهِ]
ولما تدرج المخاطب إلى هذه الحال الجديدة، المتصف معها بجميع هذه الأوصاف.. اتخذ منه الشاعر، إذن ملاذا وملجأ، لمد يد العون والمساعدة، التي توسمها فيه فخاطبه قائلا:
[أعِنِّي بِصَوْبِ الدَّمْعِ مِن بَعْدِ صَوْنِهِ
وَنَشْرِ سَرِيرِ الشَّوْقِ مِنْ بَعْدِ طَيِّهِ]
وبعد أن استطاع الشاعر أن يتدرج بالمخاطب إلى هذا المستوى من التميز والانفصال، وطلب منه إسداء خدمة معينة، نبهه إلى مبدأ قويم من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المصاحبة الصادقة الحقة:
[فَمَا أنْتَ خِلُّ الْمَرْءِ فِي حَالِ رُشْدِهِ
إذَا كُنْتَ لَسْتَ الْخِلَّ فِي حَالِ غَيِّهِ]
هذا بعض ما يحضرني، من ذلك الدرس الشيق، الذي استهل به الأستاذ جمال، تدريس الأدب الموريتاني، في كلية الآداب، في جامعة نواكشوط.
ولكم أن تتصوروا معي بحق، كيف أن هذه الصور كما عرضتها، لا بد تدرجت هي الأخرى كما وقع لذات الشاعر المُخَاطَبَة، ولكن بصورة عكسية هذه المرة، فانتقلت من صور نيرة ناصعة مؤداة بتعبير واضح رصين، كما أطلقها صاحبها أول مرة، لتصبح اليوم بفعل تقادم العهد وضعف الجهد والتفكير المتردي وعجز المؤدى، لتصبح باهتة كالضمير المستتر في صدر البيت الأول، من قطعة الشاعر ابن أحمد يوره.
أذكر يومذاك أن أحد الطلاب تدخل في نهاية الدرس فقال: يا أستاذ إما أن يكون الشاعر متقدما على عصره، أو تكون أنت قد حمَّلت النص أكثر مما يتحمل!
فأجابه جمال بداهة: أما أن يكون الشاعر متقدما على عصره، فهذا ليس بمستحيل، و أما أن أكون أنا قد حمَّلت النص أكثر مما لا يتحمل، فاعلم بأن النص أي نص لا يحمل من المعنى إلا ما حمَّله إياه قارئه.. وقد يأتي قارئ آخر فيحمل هذا النص أكثر مما حملته أنا بكثير..
وتدخل طالب آخر فقال: يا أستاذ أنت تلفظ "المدروم" براء مرققة.. هل سمعت الشاعر ينطقه كذلك؟ فأجاب جمال: أنا لم أسمع الشاعر ينطق المدروم براء مرققة، وأنت كذلك لم تسمعه ينطقه براء مفخمة.
وأثناء الدرس لفت انتباهي طالب يجلس في الصف الأول، لم يتم مقطع من الدرس إلا وأبدى عليه ملاحظة. وكان الأستاذ جمال حريصا على أن يجيبه على كل ملاحظة، وبصورة سريعة لا ينقطع معها حبل تفكيره، ولا يتهلهل سبك تعبيره.
مرة قال الأستاذ في شرح البيت الأول من قطعة ابن أحمد يورة: إن معنى حيِّه في قول الشاعر:
[على الربع بالمدروم أيه وحيه] قد تكون بمعنى ٱطلُبْ له الحياة التي تكون بالنسبة للربع بفعل المطر. قال الطالب: "ليس ذلك بالضرورة يا أستاذ"! فرد الأستاذ جمال بداهة: "طبعا، ولذلك قال طرفة بن العبد: [غَيْرَ مُفْسِدِهَا] ثم واصل الدرس، وهكذا دائما تجيء ملاحظات الطالب وتأتي وفقها إجابات الأستاذ.
وللتوضيح فالأستاذ وتلميذه يشيران هنا إلى البيت المشهور لطرفة بن العبد:
[فَسَقَى بِلاَدَكَ غَيْرَ مُفْسِدِهَا
صَوْبُ الْغَمَامِ ودِيمَةٌ تَهْمِي]
هذا ولما اكتمل الدرس أحاط به، الطلاب، والأساتذة، يستبشرون ويستفسرون عن البرنامج الجديد، وما هي ملامحه، وما هي الجدولة المعدة له، وعن المواضيع اللاحقة منه.
وبعد جهد جهيد خرجنا من حرم الجامعة عائدين، فمكث الأستاذ برهة وكأنه شارد الذهن. قلت له: ما بالك؟ قال: كادت ملاحظات أحد الطلاب تربك تسلسل تفكيري في صلب موضوع الدرس.. إنه الطالب النابه عبد الله السالم ولد الْمُعَلَّى، وهو ليس من طلابنا في السنة الأولى!!
وأختم فأقول: يا ليت معالي وزير الثقافة السابق، والصديق الوفي، والأديب الأريب، يثري ساحتنا الثقافية، والأدبية، فيتقاسم معنا ما علق في ذاكرته من ذلك الدرس المشهود، المؤذن بانطلاق عهد جديد، في تاريخ الأدب الموريتاني.. إن في ذلك خدمة للوطن ووفاء بالعهد.

.jpg)