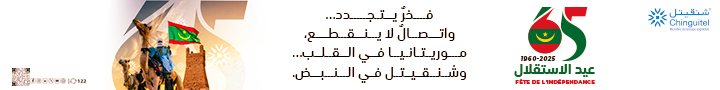المواطنة واستحقاقات الجمهورية/ المختار محمد يحيى

في غمرة الحديث عن قرب تنظيم الحوار الوطني الجامع الذي لا يستثني موضوعًا ولا أحدًا، ومع بدء التمهيد له من خلال لقاء فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لفرقاء الساحة السياسية الوطنية، أغلبيةً ومعارضةً، المزمع قريبًا، وبعد تحقق جملة من المكاسب الوطنية الهامة خلال الست سنوات الماضية، صار لزامًا أن نعترف بحكمة ونجاعة السياسات التي ميزت أسلوب وتوجه الحكم وتسيير البلد، وتلك المواقف والمبادئ الجمهورية الهامة التي عبّر عنها فخامة رئيس الجمهورية في خطاباته، وتجسدت في منجزات الدولة وترتيباتها في مختلف مناحي الحياة.
لقد كانت خطابات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني خلال كل من المأمورية الأولى والعام الأول من المأمورية الجارية خطاباتٍ تاريخيةً تقوم على التأسيس لواقع جديد وقطيعة مع الماضي، بهدف الانطلاق نحو مستقبل زاهر للشعب الموريتاني والتفرغ للتنمية والنهضة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك بتخطي عقبات التخلف من جهل وفساد، والشعور الفئوي المنافي لقيم مجتمعنا الإسلامي السمحة.
وكلنا يذكر خطاب وادان التاريخي سنة 2021، الذي شكّل الخطاب الرئاسي الفيصل في مسألة المواطنة من خلال تثمين الوحدة الوطنية ومحاربة الفئوية، وجميع الأمراض وأعراضها من صور نمطية مسيئة لبعض المكونات، فكان بحق الخطاب المنتظر لدى فئة كبيرة من المواطنين ممن عانوا التهميش والإقصاء خلال عقود من عمر الدولة المركزية بعد استقلال البلاد من ربقة الاحتلال في نوفمبر 1960.
إن المواطنة أخذت حيزًا هامًا في خطابات فخامة الرئيس، كما رأينا ذلك خلال زيارة فخامة الرئيس للحوض الشرقي، فهي لا تأتي في مقابل القبلية والجهوية فحسب، بل تأتي أيضًا في وجه غياب روح وتجسّد المؤسسات الجمهورية ودولة القانون. فبدون عدالة وإنصاف ومساواة يكون حديثنا عن المواطنة أقرب إلى الطوباوية والخطابات الشعبوية، لكن رئيس الجمهورية وضع الأسس والدعائم، وقبلها الإرادة السياسية الصادقة، لإطلاق تغيير جذري في أسلوب الحياة العمومية مبني على الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، ومكافحة التهميش والغبن، لذا صار بالإمكان الحديث بثقة عن المواطنة لما تعنيه من إيمان وواجبات وحقوق للفرد تجاه الدولة والعكس.
لقد غدت المواطنة معيارًا حاسمًا لقياس نضج التجارب السياسية وقدرتها على الاستمرار، فبالعودة إلى تاريخنا الوطني نرى أن المواطنة قد اكتسبت بعدًا خاصًا، لأنها تتقاطع مع تاريخ سياسي متقلب، وبنية اجتماعية معقدة، وتطلعات متزايدة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وعدلًا. فالحديث عن استحقاقات المستقبل السياسي لموريتانيا لا يمكن فصله عن السؤال الجوهري المتعلق بنوعية العلاقة التي تربط المواطن بالدولة، وحدود الحقوق والواجبات، وطبيعة المشاركة في الشأن العام.
إن المواطنة في معناها العميق تفترض المساواة أمام القانون، والتمتع بالحقوق دون تمييز، والالتزام بالواجبات العامة، غير أن هذا التصور واجه في السابق تحديات حقيقية في بلادنا. فالفوارق الاجتماعية، وضعف العدالة في توزيع الفرص، وتفاوت الوصول إلى الخدمات الأساسية، كلها عوامل تُضعف الإحساس بالانتماء المشترك، وتؤثر سلبًا على الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ومع إرادة الإصلاح التي بشّر بها فخامة رئيس الجمهورية بدا الحلم أقرب إلى التحقق.
إن المستقبل السياسي للبلاد إنما يرتبط بمدى القدرة على تجاوز هذه الإشكالات، وبناء دولة تقوم على سيادة القانون والمؤسسات بدل الأشخاص. فالديمقراطية لا تُقاس فقط بالنجاح في تنظيم الانتخابات، وبمدى نزاهتها، بل بقدرة المواطن على الوصول إلى حقوقه غير منقوصة، وبوجود إدارة عمومية تحترم الكفاءة وتكافؤ الفرص. وفي هذا الإطار، شكل الفساد أحد أكبر العوائق أمام ترسيخ المواطنة، وهو ما جعل من محاربته الشغل الشاغل لنظام فخامة الرئيس من خلال محاسبة الضالعين استنادا إلى مؤسسات الرقابة التي باتت تعمل باستقلالية تامة، وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد إذانا بإشراك المواطنين والجهات المدنية في الإبلاغ عن شبهات الفساد، ذلك المرض الذي يقوض مبدأ المساواة ويعمق الشعور بالإقصاء، ويحوّل الدولة إلى غنيمة بدل أن تكون إطارًا جامعًا للجميع.
كما أن استحقاقات المستقبل السياسي والطفرة الاقتصادية الباديةُ مؤشراتها بحمد الله، تفرض إعادة النظر في دور الشباب والنساء في الحياة العامة. فهؤلاء يمثلون جزءًا أساسيًا من النسيج الاجتماعي، مما يستلزم تعزيز حضورهم في مراكز القرار، وقد قطع النظام شوطًا كبيرًا في ذلك المضمار، خصوصًا مع منح مقاعد في الجمعية الوطنية للشباب، وإنشاء قطاع خاص بتمكينهم وتشغيلهم. فإشراك الشباب بفعالية يجب أن يكون خيارًا استراتيجيًا يعكس الإيمان بأن تجديد النخب شرط أساسي لتجديد السياسة نفسها. ولا يمكن إغفال دور التعليم والإعلام في هذا السياق، فبناء وعي مدني راسخ يبدأ من المدرسة، ويتعزز عبر خطاب إعلامي مسؤول يكرس قيم المواطنة، ويبتعد عن تأجيج الانقسامات أو تبرير الإقصاء.
وهنا، وفي سياق حديثنا عن الإعلام ودوره في التوعية الاجتماعية، تظل الوحدة الوطنية إحدى القضايا المركزية في النقاش حول المواطنة. فإدارة التنوع الثقافي واللغوي والاجتماعي تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على بناء هوية جامعة لا تلغي الخصوصيات، لكنها لا تسمح بتحولها إلى أدوات صراع. ولا يمكن تحقيق ذلك دون مقاربة جادة للعدالة الاجتماعية، ومعالجة آثار المظالم التاريخية، في إطار وطني هادئ يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
إن هذا الموضوع الشائك، الذي يحيل مباشرة إلى ملف الإرث الإنساني والمظالم التاريخية، بين من يرى بضرورة علاجه من جديد، وبين من يعتبر أنه صار من الماضي بعد تسويته التي أشرفت عليها المفوضية السامية للاجئين قبل قرابة العقدين، لا بد من التفكير فيه بطريقة منصفة وعادلة تضمن العلاج الحقيقي لآلام الماضي، قائمة على الاعتراف والاعتذار، وتخطي تلك المأساة التي تشكل ندبة عميقة في تاريخنا المعاصر.
لا شك أن أخذ العبرة من التجارب المماثلة في العالم بإمكانه أن يدعم هذا التوجه، ففي مقاربة العدالة الانتقالية، والحديث بشفافية ومسؤولية في الإعلام العمومي عن تلك الأحداث، والاعتراف بمعاناة المتضررين وتعويض ذوي الضحايا، لا يُعد ذلك استدعاءً للماضي بقدر ما هو مسار علاجي يهدف إلى طي صفحته على أسس سليمة، لتلتئم الجراح بعيدًا عن الضغائن والأحقاد، ويُؤسَّس لمستقبل جديد من التآخي والتراحم والتلاحم بين مختلف أطياف المجتمع.
وفي سياق متصل، لا يمكن إغفال نجاعة المقاربة المتكاملة التي انتهجتها الدولة في محاربة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين، حيث قامت هذه السياسة على التوازن بين البعد الأمني والبعد الإنساني، واحترام الالتزامات الدولية، وحماية السيادة الوطنية في آن واحد. وقد أسهم هذا النهج في الحد من الظواهر المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز صورة البلاد كشريك موثوق في إدارة هذا الملف المعقد، دون الإخلال بحقوق الإنسان أو المساس بكرامة المهاجرين، مما يعكس نضج الرؤية السياسية وحسن تقدير التحديات الإقليمية والدولية.
كما برهنت الدولة، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، على قدرة عالية في بث الاستقرار والأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين، رغم ما يحيط بالبلاد من محيط إقليمي مضطرب، تتداخل فيه التهديدات الأمنية والتقلبات السياسية. فقد حافظت موريتانيا على استقرارها الداخلي، ورسخت ثقة المواطن في مؤسساته الأمنية والعسكرية، من خلال سياسات استباقية وحكيمة جعلت من الأمن ركيزة أساسية للتنمية، وأساسًا لطمأنينة اجتماعية ساعدت على توجيه الجهود نحو البناء والإصلاح بدل الانشغال بمخاوف عدم الاستقرار.
إن النجاحات الهامة التي تحرزها موريتانيا في مختلف المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية هي نجاحات تؤسس لحاضر مختلف عن الماضي، كما أنها تفتح الباب أمام مستقبل مشرق للبلاد، من الأفضل أن نعبر إليه في وضع داخلي قوي ومتماسك اجتماعيًا، ومدعوم بقوة مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وتعزيز ثقة المواطن في الدولة، لكي تنعكس في مدى تمثله وإيمانه بالمواطنة وتطبيقها في حياته وتوريثها لأجيال المستقبل.

.jpg)